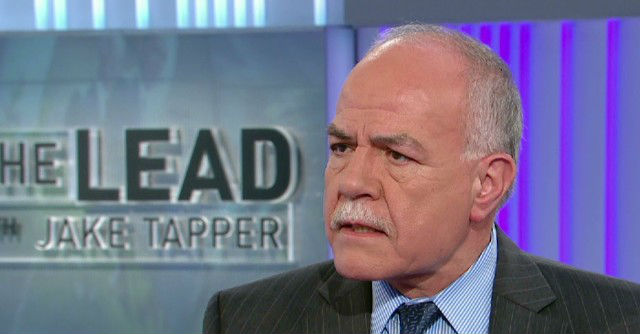
قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب القوات الأميركية من شمالي سوريا، عشية اجتياح الجيش التركي وإخفاقه في حماية حلفاء الولايات المتحدة الذين خاضوا معها معارك طاحنة ساهمت في هزيمة إرهابيي “الدولة الإسلامية”، ولاحقا نبذه للكرد وحتى تحقيرهم، له أبعاد تتخطى أثاره الكارثية الآنية على حلفائه المحليين، لتؤكد حقيقة تتوضح يوميا، وهي أن “لحظة” أميركا التاريخية في الشرق الأوسط قد دخلت مرحلة الأفول.
بدايات “الانسحاب” الأميركي من المنطقة سبقت حقبة ترامب، وإن كان الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة يفتقر حتى إلى الفضول الفكري لمتابعة تعقيدات السياسة الخارجية الأميركية في العالم ككل، وتحديدا في منطقة قديمة ومعقدة عصي أسلافه عن حل مشاكلها على الرغم من الحروب المكلفة التي خاضتها الولايات المتحدة في العقود الماضية واكتشفت فيها محدودية قوتها العسكرية في جبال أفغانستان وصحاري العراق.
صحيح أن ترامب يفاخر بأنه رئيس “غير تقليدي”، وهذا صحيح، وأنه يريد إنهاء “الحروب التي لا نهاية لها” في المنطقة، وهذا أيضا صحيح ولكن فقط جزئيا، إلا أن رغبته بتقليص الوجود العسكري الأميركي والتزامات واشنطن الأمنية في منطقة جغرافية شاسعة تبدأ من جنوب آسيا، وتمر بالخليج والشرق الأوسط وتنتهي في شمال أفريقيا، تنسجم مع مواقف شريحة كبيرة من الأميركيين وربما مع أكثريتهم.
هناك تعب أميركي من مشاكل وتحديات الشرق الأوسط، وخاصة منذ حربي أفغانستان والعراق، وهما أول وثاني أطول حربين في تاريخ البلاد، لم تستطع الولايات المتحدة أن تحقق في أي منهما “انتصارا” بالمعنى التقليدي للكلمة.
اقرأ أيضاً: العراق.. ابعد من ثورة الجياع: جيل جديد من المحتجين يهزّ أركان السلطة
صحيح أن أميركا هي التي غزت البلدين: في حالة أفغانستان للرد المشروع على اعتداءات سبتمبر 2001، ولكن في حالة العراق فإن الغزو كان لإعادة هندسة وتشكيل العراق ربما على صورة أميركا، في اعتقاد ساذج من قبل إدارة الرئيس جورج بوش الابن بأن الإطاحة بنظام الطاغية صدام حسين ستؤدي بسرعة إلى ولادة نظام ديموقراطي.
وعندما يكرر ترامب القول إن الحكومات الأميركية على مدى العقود الماضية أنفقت 8 ترليون دولار عل سياسات فاشلة في المنطقة، وهو مبلغ مبالغ به كثيرا، فإن مثل هذه الشكوى تجد لها صدى إيجابيا.
أوباما ورغبته بتحرير نفسه من الشرق الأوسط
خلال ولاية الرئيس باراك أوباما، تدخلت الولايات المتحدة عسكريا في ليبيا وساهمت بالإطاحة بنظام معمر القذافي، كما تدخلت بشكل محدود في الانتفاضة السورية، وحاولت إحياء عملية المفاوضات بين العرب وإسرائيل.
ولكن أوباما، كان يريد أيضا تقليص الدور الأميركي في المنطقة، وهذا ما يفسر انسحابه من العراق في 2011 قبل تحصين الدولة العراقية ضد الأخطار الداخلية والخارجية، ومعارضته لتسليح المعارضة السورية بشكل جذري يهدد نظام بشار الأسد.
الرئيس أوباما، في سنواته الأخيرة، ركز اهتمامه على التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، حيث كان يأمل بفتح فصل جديد من العلاقات مع إيران، ربما مماثل للعهد الجديد الذي فتحه الرئيس ريتشارد نيكسون مع الصين في سبعينيات القرن الماضي.
ولم يكن سرا أن أوباما، الذي حققت الولايات المتحدة في عهده نقلة جذرية في إنتاج النفط قلصت من اعتماد الولايات المتحدة على نفط الخليج، كان يرغب بالتركيز أكثر على شرق آسيا وهي المنطقة الأكثر نموا اقتصاديا في العالم.
وما شجع أوباما على التوجه إلى الشرق هو إرهاقه من مشاكل الشرق الأوسط وقادته وهو الذي لم يرتبط بأي علاقة جيدة مع أي قائد عربي، وكانت علاقاته برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو سيئة منذ البداية وازدادت سوءا مع مرور الزمن.
علاقات أوباما بقادة الخليج أيضا كانت سيئة وخاصة بعد أن “تخلى” برأيهم عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في 2011، وبعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران.
في العام 2016 وصف أوباما حلفاء أميركا في الخليج، وتحديدا السعودية، بأنهم يريدون زجّ الولايات المتحدة في نزاعاتهم المذهبية (مع إيران) ويريدون الاعتماد على القوة العسكرية الأميركية بطريقة ليست مفيدة للولايات المتحدة ولا للمنطقة. وأضاف في مقابلة مع مجلة أتلانتيك أن على السعودية أن “تجد طريقة فعالة لمشاركة المنطقة” مع إيران. أوباما، كان يشعر بالإحباط لأنه لم يستطع تحرير نفسه أكثر من مشاكل الشرق الأوسط للتفرغ أكثر للمنطقة الاكثر أهمية: الشرق الأقصى.
ترامب والمد الأوتوقراطي
المد الديمقراطي الذي شهده العالم بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991، بدأ يتعثر في أواخر العقد الأول من القرن الحالي، حيث استخدم زعماء شعبويون، أو ذو ميول وتوجهات أوتوقراطية الانتخابات والتلاعب فيها كوسيلة لتقويض الديمقراطية وخاصة في الدول التي لم تتطور فيها المؤسسات والقيم الديمقراطية بشكل سليم ومتكامل. وأفضل من يمثل هذه الظاهرة زعماء مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتركي طيب رجب أردوغان، والمصري عبد الفتاح السيسي.
هذه الظاهرة وصلت إلى أوروبا حيث يمثلها بشكل نافر رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، الذي استغل مخاوف الهنغاريين من الهجرة لتقويض الديمقراطية في دولة أوروبية.
وخلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين حققت الأحزاب اليمينية والشوفينية في دول أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا نجاحات انتخابية هامة. وهناك ممثلون لهذه الظاهرة في آسيا مثل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، وفي أميركا اللاتينية مثل رئيس البرازيل جايير بولسونارو.
معظم هؤلاء القادة يبالغون بأخطار الهجرة واللاجئين، ويميلون إلى الانعزالية والخوف من الآخر. في 2016 انتخب الأميركيون رئيسا شعبويا، انعزاليا، يشكك بالقيم الليبرالية وبأهمية وجدوى التحالفات والمنظمات الدولية، على الرغم من أن معظمها، مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو) أسستها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية واستخدمتها لبسط نفوذها في العالم.
الرئيس ترامب لا يعرف القضايا والأزمات العالمية، وهو في الواقع غير مهتم بمعرفة العالم، باستثناء معرفة سطحية بالدول التي تتواجد فيها الفنادق والنوادي التي تحمل اسمه. ترامب انعزالي وتتسم انعزاليته بعدائية تجاه العالم الخارجي والتورط في مشاكله. انعزالية مماثلة للانعزالية التي تعود لعقد الثلاثينيات من القرن الماضي بشعارها “أميركا أولا” الذي “لطشه” الرئيس ترامب، ربما دون معرفة بجذوره وأهميته آنذاك للقوى الأميركية الانعزالية التي أرادت عدم مساعدة الدول الأوروبية ضد خطر الفاشية والنازية.
الرئيس ترامب، هو أول رئيس تنضح مواقفه بتعصب ضد المهاجرين من أفريقيا والعالم الإسلامي وأميركا اللاتينية منذ ولاية الرئيس وودرو ويلسون قبل قرن. ترامب يصف نفسه “بالقومي” وهذا الوصف يعني ضمنا (الأبيض) ولا يصف نفسه كما يفعل الرؤساء ومعظم المواطنين الأميركيين “بالوطني”، وهذا يعني ببساطة حب الوطن من قبل المواطن بغض النظر عن عرقه ودينه وجنسه.
عدم اهتمام ترامب بالعالم، وتخوفه من الآخر، يعني عمليا أنه غير مهتم بممارسة الدور القيادي العالمي الذي التزم به جميع الرؤساء الأميركيين من جمهوريين وديمقراطيين، وتحديدا منذ الحرب العالمية الثانية.
ولذلك انسحب الرئيس ترامب من اتفاقية الشراكة الاقتصادية لدول حوض المحيط الهادئ، كما انسحب من اتفاقية باريس للتغيير البيئي. شكوكه بجدوى حلف الناتو، ساهمت في توتير علاقاته مع قادة أوروبا، وانسحب ترامب من الاتفاق الدولي النووي مع إيران دون استشارة الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق ومن بينها دول حليفة تاريخيا لأميركا. ونجح ترامب حتى في توتير علاقات واشنطن التقليدية الجيدة مع جارتيها الوحيدتين: كندا والمكسيك، وهذا “إنجاز” غير مسبوق لرئيس أميركي.
ترامب لا يريد اتفاقات تجارية دولية، ويسعى فقط إلى اتفاقات ثنائية، ومن هذا المنظور ترامب ليس جمهوريا بالمعنى التقليدي، لأنه لا يشارك الجمهوريين إيمانهم القوي ـ تقليديا ـ بالتجارة الدولية الحرة.
وسوف يواصل الرئيس ترامب “انسحابه” التدريجي من الشرق الأوسط، حتى ولو نشر بضعة آلاف عسكري أميركي في السعودية عقب الاجتياح التركي لشمالي سوريا “لأن السعودية وافقت على دفع الكلفة الكاملة” لهذا الانتشار. الاتجاه إذن، هو لانسحابات إضافية من المنطقة والعالم. وما يجعل هذا الانسحاب مقلقا لحلفاء أميركا في الشرق الأوسط وخارجه هو التقلبات السريعة والمواقف المتناقضة والمتلاحقة التي يتخذها ترامب بمفرده في معظم الأحيان، كما فعل خلال مكالمته الهاتفية مع نظيره أردوغان حين وافق آنذاك على سحب القوات الأميركية من أمام الاجتياح التركي لسوريا، وهي الخطوة التي فسرت على أنها كانت بمثابة الضوء الأخضر للغزو.
المعضلة الكبيرة التي يمثلها “الانسحاب” الأميركي من شؤون وشجون العالم، تتمثل بأننا نعيش في عالم تهيمن عليه كونفدرالية غير رسمية من شخصيات أوتوقراطية أو ديكتاتورية مثل بوتين، وأردوغان، وشي جينغ بينغ، وناريندرا مودي، وعلي خامنئي، والأمير محمد بن سلمان، والسيسي، وجايير بولسونارو وغيرهم.
تراجع أميركا عن دورها القيادي التقليدي، فتح المجال لهؤلاء اللاعبين بالتصرف بعدائية غير ملجومة: الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم في أوكرانيا وتفجير حرب انفصالية في شرق أوكرانيا، التدخل السعودي في حرب اليمن، التدخل العسكري لإيران وروسيا وتركيا وإسرائيل في الحرب السورية، التدخل الهندي في الشؤون الداخلية لولاية كشمير والذي أدى إلى انتهاك الحقوق السياسية والمدنية للسكان المسلمين، وكذلك محاولات الصين تقليص حريات المسلمين الصينيين المعروفين باسم “أويغور” حين وضعتهم في معسكرات “تعليم” خاصة.
في مرحلة ما قبل ترامب، كان العالم في مواجهة مثل هذه الأخطار والتحديات ينظر إلى أميركا للتحرك، وللتدخل بشكل أحادي الجانب أو جماعيا لإيجاد حلول، لأزمات حتى ولو لم يكن لأميركا أي مصالح في مناطق النزاع هذه.
في تسعينيات القرن الماضي تدخلت الولايات المتحدة لوقف المجازر بحق المسلمين في البوسنة وكوسوفو، وتكبدت تكاليف مالية باهظة دون أن تكون لها مصالح استراتيجية أو اقتصادية هامة في البلقان.
في العقد الأول من القرن الحالي تدخلت الولايات المتحدة لمساعدة سكان دارفور في السودان وأنفقت مئات الملايين من الدولارات لحماية المدنيين من حرب “إبادة” (هذا الوصف الذي استخدمه وزير الخارجية الأسبق كولن باول) كانت تشنها ضدهم ميليشيات موالية للحكومة السودانية.
وحتى في مواجهة تحديات الأوباء، التي لا تعترف بالحدود السياسية، ينظر العالم للأميركيين للعب دور قيادي بحثا عن الحلول. الرئيس أوباما “تدخل” في شؤون دول غرب أفريقيا، حين أرسل حوالي 4 آلاف جندي لإقامة مستشفيات ميدانية لاحتواء ودحر مرض “الأيبولا”. أوباما لم يطالب هذه الدول بدفع تكاليف هذا التدخل الأميركي، لأنه يدرك أن واشنطن من خلال مساعدة دول غرب أفريقيا في التصدي لهذا المرض العابر للحدود والقارات فإنها كانت أيضا تساعد نفسها.
إدارة الرئيس ترامب، هي الأولى منذ 75 سنة ليست مهتمة بنشر قيم وتقاليد الديمقراطية في العالم. في السابق كان قادة الدول السلطوية يشكون من الرؤساء الأميركيين الذين كانوا يميلون إلى إلقاء المحاضرات عليهم حول جدوى وأهمية القيم والمؤسسات الديمقراطية. الآن لا أحد يشكو من هذا الصمت الأميركي المريب. ما نراه الآن هو بداية النهاية “للحظة الأميركية” التاريخية في الشرق الأوسط.
تخلي الرئيس ترامب وبهذا الشكل السافر عن حلفاء أميركا في سوريا، ستكون له عواقب سلبية للغاية، ولكنه غير مفاجئ. وإذا انتخب ترامب لولاية ثانية، عندها سوف يتحرر كليا من أي اعتبارات أو قيود أميركية أو دولية للتعجيل أكثر من عملية الانسحاب من شؤون وشجون العالم، وتركه عرضة لطموحات وجشع الأوتوقراط و “الرجال الأقوياء” من المعادين للقيم الليبرالية وحتى الطغاة غير الخجولين الذين سيعيثون الفساد والخراب في عالم تخلت عنه أميركا.

