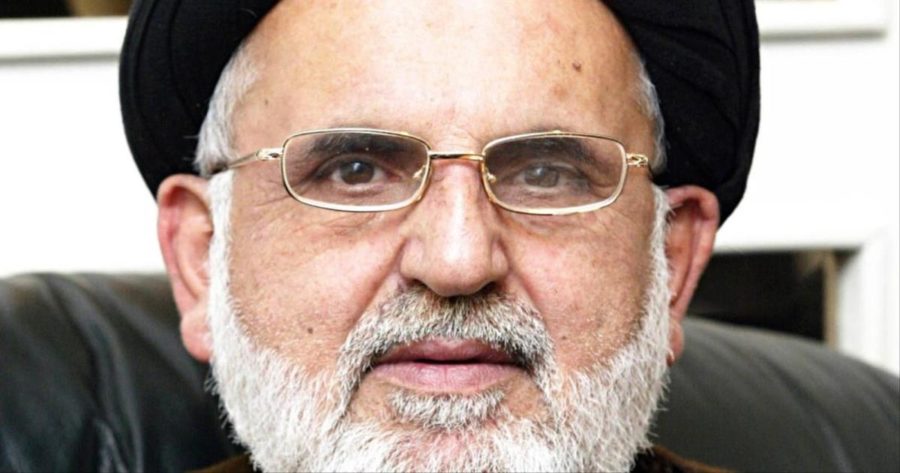
كثيرون مثلي من شركاء الدكتور إبراهيم بيضون، في قلقه المعرفي وأسئلته، ينتظرون إشارة إلى طلب أو غرض لا بد أن يكون مشروعاً وجميلاً، من طرفه، وكأنهم يمنون أنفسهم بأن التلبية السريعة للطلب، سوف تكون نوعاً من مكافأة خالصة، وطيبة، وأطيب من الحلال، بل قد تكون واجباً له، على أهل المعرفة والذوق، الذين يخلون بشروطهم الذاتية والإنّيّة، إذا لم يتفقوا على العناية والوفاء لبعضهم بعضاً، والتقييم والتقدير غير المحابي أو المجامل، لإنجازات المبدعين منهم. وفي هذه المكافأة، إلى ما فيها من لذة، تعويض عن نقص، في طقوس وتعبيرات العرفان الاجتماعي لأهل المعرفة وناشريها بين الأجيال، مع ما يلزم في هذا المقام من التماس العذر لمن لا يقرؤون، أو يقرؤون قليلاً، أو لا يقرؤون عميقاً، أو لا يقرؤون إلا ما يكتبون، وإن كنا نشاهد في أهلنا البسطاء ميلاً أو استعداداً قوياً للانبهار بالمبدعين ومودتهم من خلال إبداعهم أو سمعتهم أو صورتهم، خاصة إذا ما كانوا يتحلون بسلوك سوي، يحول العلم إلى سجية أخلاقية، ليدرك المتلقي بسهولة، أنه تواضع متأت من معرفة، يغتفر معه التعالي لا الاستعلاء، فكيف بالتواضع والدماثة والألفة التي يتقنها كثيرون، ويتميز ويمتاز بها الدكتور إبراهيم بيضون، الذي تغري دماثته بمضايقته، حتى إذا حوصر بجهل أو تجاهل أو جاهلين، تحول إلىأسد هصور، من دون مخالب أو أنياب قاطعة أو صواريخ سكود، يزأر ولكن علماً وأدباً وحكمة.. والكلام، حتى لو كان الصوت خفيضاً والمتكلم وقوراً، فإنه قد يكون كلاّماً.. ولطالما علّمت كلمات الدكتور بيضون، في معرض مقارعة الحجة بالحجة والرأي بالرأي، على علم وسداد بيّن، لطالما علمت في جلدي على نعومتها وتجاوزت الجلد إلى العقل والقلب، أما إذا كان جلد المخاطب سميكاً، وكان حاجباً لعقل وقلبه، تحولت الكلمات إلى سياط، لا يقلل من آثار لذعها إلا عودة سريعة من الدكتور بيضون إلى أدبه، أي طبعه وطبيعته، ورحمته التي تضوع منها رائحة الجوري من فستان بنت جبيل أو رائحة عطر شرقي نجفي عالق بأردان جبة السيد عبد الرؤوف فضل الله الذي يتشبث الدكتور بيضون بحضوره الساطع في وجدانه.. ولا يتحرر منه، ولا يريد، حتى عندما يستبرد صيفاً، في جدول من حنان خيامي، أوله في الساحة وآخره في الدردارة، ويغريك بالبحث عن مصاهرة لك في الخيام، ولو بعد فوات الأوان.
اقرأ أيضاً: أوصي الشباب بـ«الحب»
إلى هذا وذاك.. فإن الاستجابة لرغبة الدكتور إبراهيم، التي يتلكأ وقد يتلعثم ويحمر وجهه عندما يعبر عنها، فيفضل أن يترك ذلك، أي التعبير عن رغبته، إلى ما أدعوه الوفاء وقد تمثل شخصاً، أعني حبيب صادق، النائب السابق، الحبيب المحب والمثقف والراعي الدائم.. ولا يتعب.. بل يُتعب.. يُتعبنا حبيب صادق، في اختراع انشغالات وتكليفات دائمة لنا، وكأنه إمام في جامع عين الحورانية في النبطية، متفرغ للإمامة والمأمومين يرهقهم حثاً على العبادة بالمعرفة، حتى لا يظلم في ناديه أو جامعه مبدع يغضب الله لغضبه.

هذه الاستجابة الآن.. كأنها فرصة يمنحها أو يتيحها لي.. لكي أقضي فرضاً، يثقل كاهلي جراء مسارعته إلى تحويل قراطيسه إلى أنواط يعلقها على صدري وصدور أصدقائه، من أهل الحب والحبر، كلما آذنوا بولادة كتاب، فيصبح كتابُك وكأنه ولد حبيب من أولاده أو كتابَه.. يوقع عليه من دون نحل أو انتحال.. كأنه ملكة النحل.. وكأن كلامه عسلك الملكي يقويفيك كل شيء قابل للتقوية. إذن فأنت الآن تدخر ماعوناً من أدم الروح وخبز المعنى تبسطه على سماط المجلس الثقافي، فسطاطنا، كفاء ما طعمت حتى سمنت، من شهي كلام الدكتور إبراهيم، في ما أحسنت في نظره، مما كتبت.
قد يشبع المال، ثمناً حلالاً لكتاب حلال أو حرام، وفي الإبداع لا يفرق الحلال عن الحرام، وعلى رأي بعض الزنادقة فإن الحرام أبدع من الحلال، والعياذ بالله. والله أعلم، قد يُشبع فيك أو في إبراهيم بيضون، حاجة شرعية نظيفة لسقط المتاع.. ولكن هذه الحاجة ليس من الضروري أن تكون حاضرة أو ظاهرة أو طاغية، عندما عين الدكتور بيضون مصادره وقمش مادته وشرع في كتابة كتابه، وعانى وجعاً في سواد عينيه وبياضهما، وبرماَ بأفراد أسرته الصغيرة، مزهرياته، على انصرافه دهراً عنهم، إلى طرسه ويراعته ودوائه مهملاً أدويته.. وكأنهم هم مجرد غيوم أو سحب عابرة أو عارضة في سماء المنزل، لا شغل لها إلا أن ترطب جو المكتبة حتى لا تصاب المصادر بالجفاف.
وتقول الصابرة العقيلة أسيرة المودة والرحمة التي تعلمت الصبر من التربية، أن لو كان ترهّب، أما كان أراح واستراح ؟ ولكنها تحتفي بحمله وجنينه ووحامه ومخاضه ومولوده، وكأنه قد تخلق وتحدر من رحمها واغتذى بدمها، مضمخاً برحمتها وفرحتها.
وهكذا يبدع المبدع من الفصل وصلاً ومن القطيعة وشيجة.. ولطالما شاهدت بعضاً من كتب إبراهيم بيضون لمعاناً في عيون أولاده ووهجاً في وجه عقيلته. وإذا ما غاب عن عيون الأصدقاء أو سمعهم، انتظروا عملاً فكرياً أو أدبياً جديداً، وعالجوا شوقهم بالغبطة أو الغيرة.. أو الحسد أحياناً، ولكنهم يحسدونه، إذا حسدوه، وكأنهم يحسدون ذواتهم أو زوجاتهم على الحمل والإنجاب والإرضاع.
ولعله علة فعلية وفاعلية تامة للإبداع، ذلك الشوق الكامن في باطن المبدع، إبان انهماكه بإبداعه أو وحامه فيه، شوق إلى إدهاش قرائه وفرح أصدقائه. إنني.. وإننا هنا، نلبي رغبة الدكتور بيضون في إكمال كتابه بقراءتنا وفكره بنقدنا وحبره بحبنا، وإصراره على الإبداع وعلى تجاوز كتابه بكتاب آخر بدهشتنا.. أو أن شوقنا إلى الإبداع الذي، في لحظة اكتماله، على يد المبدع، أياً كان، يخرج عن ملكية صاحبه إلى ملكية أصحابه، يصبح مشاعاً أغلى عليك من مخدع مكان أخص خصوصياتك، وكلما كثر مالكو الفكر واختلفوا عليه كلما ازدهر واستقر، وكلما عمّ خصّ وكلما خصّ عمّ، وكلما بذل نما، على عكس المال الذي يضطرب إذا ما تعدد مالكوه ويتبدد إذا ما اختلفوا، أما إذا أصبح حكراً فقد أصبح كفراً.. يقول علي: “العلم يزكو على الإنفاق، والمال تنقصه أو تُنقصه النفقة”.. كأن العلم يشبه الوطن.. أو كأن العلم هو الوطن، أو كأن الوطن هو العلم، وراقبوا معي كيف ينوص هذا الوطن جراء تداول الجهلاء له من دون دولة. هذا كلام مني أو لي، يريد أن يهدي إلىإبراهيم إضمامة من خصائصه التي يعيشها وقد لا يراها، ونحن نراها، لأن لنا مسافة بين الذات والموضوع، هذا إذا ما كانت ذاتاً غير مريضة بحالها وكانت الموضوعية متيسرة في حالة من تناوب الحب والإعجاب على شخص واحد.. وهو، أي كلامي، عصارة خبرة، من دون أن تكون منسوبة إلى تطابق إلا في النزوع، إلى الواقعية والعقلانية، إلى النشأة والمسيرة العصامية، إلى النزوع إلى المساءلة، وجنوح القلب، الدرب السري إلى الله والمعرفة به وبالحياة التي دعانا إليها وشبه الحياة الأخرى بها لا العكس.
هذا المشغول المشتغل بنقد الماضي، مقدمة ضرورية لنقد المستقبل، هذا المنهمك بالتمييز بين ما مضى وانقضى وما مضى رانياًإلى غدنا كأنه من غدنا، لأنه جميل وضروري ضرورة الذاكرة للرؤى والأحلام، لا يكتب تاريخاً رغبة أو ترغيباً بالهجرة، أي استخدام الماضي آلة أو ذريعة لاستدبار المستقبل.. هو إنسان يؤنس ويؤانس على قلق، شأن أبي حيان التوحيدي، وكأبي حيان يكتب مدججاً بحساسية عالية وعفة بالغة وزهد محرر من رق الأغراض والأعراض، ورغبة في معاقرة الجواهر لا المجوهرات إلا في معاصم كريماته وكناته حيث يحيل النقش إلى النص، وتتماهى الفضة بالورق، وهي، الفضة، معنى الورق في لغتنا كما في قصة أهل الكهف، ومن هنا صار الأدب شعراً ونثراً، لا زينة في مقام معرفته وفضاءات علمه، بل تقصيراً أو تقريباً أو إلغاء للمسافة بين الذات والموضوع، بين المهجوس والملموس، حتى يثبت لك صحة وصية الماوردي ووجوب تنفيذها بالأدب والتأدب والتأديب لأنه تهذيب.. فكيف إذا تأدب العالم أو علم الأديب ؟ وأعني إبراهيم بيضون في الحالين.
ولدى إبراهيم بيضون يلتبس الأدب بالذهب والتهذيب بالتذهيب من دون أن يلتبس الإيمان بالتمذهب أو الموقف أو التاريخ بالتحزب.
هكذا يتحرر إبراهيم بيضون في حياته وسيرته.. ويعم حتى يصبح شراكة ويخص حتى كأنه يتيم.. أي فريد.
ولولا الفرادة، لما كان لمفكر أو فنان أن يحقق أو يتحقق. إبراهيم بيضون مشبع، خلقةً ودربةً، بفرادة، حوّلته إلى مؤرخ تغريك حريته وشجاعته إلى حد أن تراه بلا هوية بسبب عمق هويته المركبة بعمق وأناقة والتي تظهر في خفائها وإخفائها وتختفي في ظهورها وإظهارها، على معنى نكران الذات تحقيقاً لسلامتها. وفي آخر البحث والكتاب تكتمل هويته بالتركيب العظيم، وتبقى مفتوحة على إنسان آخر.. مختلف طبعاً..وعلى رأي آخر، على الرأي الآخر.
اقرأ أيضاً: لبنان من إيران وجع الحرف
أما كان أكثر فائدة للشيعة والتشيع، وأكثر مطابقة للشيعة والتشيع، نشأةً ومساراً ورؤية ترجيح العام على الخاص أسوة بعلي: “لأسلمنّ ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة”؟ وتحفظ وجودها وحيويتها وخصوصياتها بالاندماج لا الفصال. يقول علي هنا: “الشاذ من الناس للشيطان كما أن الشاذ من الغنم للذئب”.. لو أن البحث عن المجالات المشتركة والعناية بإنتاج المعرفة المشتركة، بقي حاكماً على نشاطهم العلمي وطريقة عيشهم، بناء على ما أسسه أئمتهم والمقتدون بهم علماً وخلقاً، لكنا الآن في أمان من الفتن والافتتان.
دعوني باسم رواد المدرسة الجعفرية وطلابها، أشكر الدكتور إبراهيم بيضون على الجهد الجهيد، الذي بذله في تنقية تاريخنا من الزؤان، مذكراً بأن كباراً وسباقين كاليعقوبي والمسعودي وغيرهما، قد أهلتهم الموضوعية لمرجعية فكرية وتاريخية عامة، ومنحت آثارهم جمالاً وعذوبة أدبية عالية، في حين أن موضوعية الطبري وابن الأثير العظيمين كانت سبباً لدى البعض لحسبانهم من الشيعة، وكأن التشيع فكرياً وفقهياً كان يعني علمياً الحياد العلمي أي الحقيقة، أي الإبداع، لأنه اجتهاد.. فأين نحن منه الآن..
بلى ما زلنا والدليل أن ثلة صافية صفيَّة.. صفوة وإخوان صفا ووفا، يحتفون بهذا العالم المنحاز إلى الحقيقة.
(من كتاب “في وصف الحب والحرب”)

