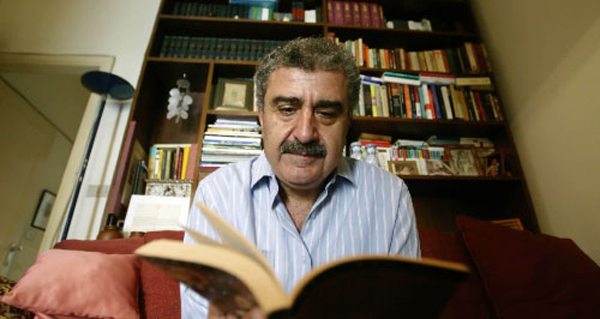
مضمون السؤال السابق، أحالني على مضمون سؤال جوهري متعلق بالكتابة الروائية العربية – بشكل خاص – طرحه على نفسه، يوماً، الروائي عبد الرحمن منيف، وهذا السؤال هو: “لقد حاولتُ، وربما منذ وقت مبكر، أن أضع أمام عيني السؤال الأساسي: ما هي الرواية العربية التي أريد الوصول إليها؟ فما هي إذن الرواية العربية التي يريد حسن داوود الوصول إليها؟
كما قلت أعلاه، لا أحسبني راغبا في اقتراح قواعد وأسس لما ينبغي أن تعتمده الرواية العربية. لكنني مقتنع مع ذلك بأن النصّ المكتوب، سواء كان رواية أو شعرا أو نصا مسرحيا إلخ… سيجد معجبين أو حتى مؤيّدين، أو حتى مؤمنين. لكن لا أجد أن ذلك الإعجاب أو التأييد سيجري مجرى التأييد للأحزاب أو التحمّس لها. ألنصّ المكتوب يؤثر مخاطبتهم كأفراد، وهو يصل إليهم من فرديتهم تلك. لم يكن الأدب والفن على غير ذلك. هذا مع أن تراثنا العربي زاخر بالكتّاب الذين سعوا إلى إصلاح مجتمعاتهم وتقدّمها عبر الكتابة. ونحن بعد طلابا في المدارس جرى تحفيظنا الكثير الكثير من القصائد الوطنية أو القومية، تلك التي تركناها في عمر الطفولة ذاك.
عبد الرحمن منيف، في ما قرأت له، كان راغبا، هو الفرد، أن يتكلّم بإسم المجموع، وأن تكون معاناته الفردية معاناة قومية. وفي الرواية كان يتساءل ما هي الرواية العربية التي يريد الوصول إليها؟ هكذا كأن شيئا من هذه الرواية لم يكتب من قبل، أو كأن الرواية هي هناك في آخر الطريق ونحن سنجدها، حين نصل إليها، ناجزة كاملة.
· روايتك الجديدة “نقِّل فؤادك”، تفيض بنقدية لاذعة، هي من سمات أسلوبك في الكتابة عموماً، فماذا بشأن عنوانها بداية؟ وما هي تحديداً رسالتُها، التي أردت توصيلها إلى القارئ وذلك نسبة لما تُثير لديه من أسئلة كثيرة ومتنوِّعة؟
أعجبتني هاتان الكلمتان: “نقّل فؤادك” وهما شائعتان على كلّ حال إذ لم يجريا على لسان أحد ممن سمعوا بهذا الإسم إلا وأعقبهما بذكر بيت أبي تمام كاملا. أعجبتني أولا صيغة الأمر فيهما، التي تصيب القلب بذاته أيضا، كأنّ أبا تمام يخاطب القلب عبر واسطته الذي هو حامله. ثمّ أنه، في ما خصّ هذه الرواية، ينقل واحدنا إلى الإعجابات الكثيرة التي تراوح بينها ما يسميه الميلودراميون بالحياة العاطفية. ولنضف إلى ذلك كلّه الحضّ على الحرّية وعلى الخفّة في ما يتعلّق بأهواء القلوب.
في العادة يستغرق مني اختيار عنوان الرواية شهرا كاملا أو شهرين. “نقّل فؤادك” اهتديت إليه في لحظة، كأنه هو الذي أتاني مقتطعا هكذا من آلاف أبيات الشعر.
أما الرواية فهي عن قطعة من الحياة ذُكر حدّها الأوّل في الصفحة الأولى أو الثانية منها: عمر الثامنة والخمسين. هذا العمر الذي، مثل كل الأعمار ربما، فاصل بين زمنين أو بين تجربتين. لكن هذه القطعة من الحياة حافظة للكثير مما كان في القطع التي سبقتها، فها هو صاحبنا المقبل على الستّين يرجع إلى عمر السادسة عشرة لكي يعمل على إتمام ما كان تركه هناك من دون حسم. الرواية تدور حول أمور كثيرة متشعّبة إلى درجة أنني كنت دائم التساؤل، في أثناء ما كنت أكتبها، إن كان ممكنا جمعها في سياق روائي.
· في “نقِّل فؤادك” يستوقِفُنا النّزوع الجامحُ، لدى الراوي، لتسييل اللغة الروائية، متمثلة بطغيان المحكيّة الصِّرفة أو الشفهية وفي مفاصل أساسية حتى، هذا إضافة إلى ما يستوقفنا من “نفي” للغة إذا صح التعبير عن مواردها الأصلية، أو تغريبها بالكامل باعتماد اللغة الأخرى، أي الإنكليزية بحرفية نُطفها وكتابتها بالحرف العربي، هذا إلى استخدام، وإن بشكل محدود جداً، كلمات فرنسية بلغتها الأصلية؛ هذا فضلاً عن المساحات الواسعة أيضاً، التي يحتلُّها الصمت المباشر؛ والإيماءات المصاحبة للكلام؛ والإيماءات البحتة، فما هو المقصود من كلّ ذلك؟
في حوار سابق حول “نقّل فؤادك” ذكرت أنها، مقارنة بما سبق أن كتبته، تبدو كما لو أنها بلا موضوع. إنها جمع لشتات مواضيع جرى تأليفها عن تجربة حياة عابرة. أما هذه الحياة، أو هذه القطعة من الحياة، فراهنة لا تبعد أحداثها عما ما زال يتردّد منها ويستكمل بعد إنهاء الرواية ثم طباعتها. تلك اللغة التي كتبت فيها، اللغة القريبة، كان لا بد لها أن تنفي (بحسب ما ذكرت في سؤالك) وقع الفصحى على سلوك شخصياتها. كانوا يتحادثون وسيارتهم في وسط زحام السيارات، وهناك في المطعم الحديث كان قاسم وتلك المرأة يجرّبان إن كان يمكنهما أن يحوّلا رفقتهما أو زمالتهما إلى علاقة، وهناك المحل الأكثر جدّة الذي يبيع قطع الكاتو الملونة إلخ… كان صعبا إزاء ذلك كلّه ألا تحضر اللغة بوجهها، بل بوجوهها المختلفة الجامعة بين شتات الكلام وخليطه.
· قاسم، بطل الرواية وراويها، تتخطّفُه لُعبةُ “الزَّمن والذاكرة” (الواقع والتخييل)، لكن، في هذا الصراع الداخلي، كان الانتصار – وببداهة الأمر – للزّمن، في النهاية؛ فما هو رأيك إذن، في تأثير الزمن على الشخص المبدع، من ناحية، وعلى عمله الإبداعي من ناحية ثانية؟ وذلك انطلاقاً، من خلال اعتمادك، في أعمالك الإبداعية كافة، على “الراوي الشاهد”.
أعجبني وصفك لحضوري في الروايات بكوني “الشاهد” أو “الراوي الشاهد”. في أكثر الروايات بدوت كما لو أنني، أنا حسن، كنت هناك. طفلا ثم فتى ثم شابّا… وهناك تعني مكانا ما أكون فيه نصف مختبىء أراقب بعيني ما يجري بين من أروي حكايتهم. لقد كنت هناك مراقبا متطلّعا حتى حين كان السرد يجري على ألسنة الأبطال أنفسهم: الشيخ المعمّر في “أيام زائدة” مثلا، أو ذلك الشاب المختلّ جسديا في “غناء البطريق”، أو رجل الدين في “لا طريق إلى الجنة”. كانوا هم يروون حياتهم، كلّ بلسانه، وهذا، في ما أحسب، جعلني أكثر حضورا بينهم. ألأحرى أنني كنت موجودا فيهم، بل أنني أدمجت نفسي فيهم فصرت، في “لا طريق إلى الجنة” أنا رجل الدين الساعي في نهاية المطاف إلى خلع عمامته.
ألصور الآتية من الماضي تحلّ فينا وقد هيأتها الذاكرة لتكون مشهدا خياليا تام العناصر. ألماضي هو الذي دفعني إلى الكتابة. مع كتابي الأول “بناية ماتيلد” كنت كأني اكتشفته عالما مفارقا، أو عالما ظلّا للعالم الذي نعيشه. قبل الكتابة كنت أتذكّر ساكني البناية بتلك الصور الخيالية ذاتها، لكني، مع الكتابة، رحت أجمع تلك الصور المتفرّقة، مؤلّفا لها، ساعيا إلى أن أصنع منها، أو من وهمها، حياة كاملة. دائما كنت محتاجا إلى أن يكون الناس هناك، بعيدين سنوات أو عقودا، منتظرين عند حافّة ما، مثل ممثلين متجمعين في الكواليس، بانتظار أن تستدعيهم الكتابة إليها.
· تُهدي هذا العمل الرِّوائي “إلى مَنْ باتوا كثيرين”؛ فمن هم هؤلاء يا تُرى؟ ولماذا خصَّصتهم بهذا التشريف وحدهم؟
يمرّ في خاطري مشهد لأصدقاء كنت بينهم في سهرة، أو في رحلة بالسيارة، أو في بلد أجنبي، فأرى مثلا أن ذاك كان المشهد الأخير الذي جمعنا معا. هؤلاء باتوا كثيرين، كأنّ الموت حلّ بيننا بأسرع ما كنا ننتظر.

