
ولدت في مستشفى بسيط بمنطقة كليمنصو، بين الحمرا وعين المريسة. أمي وأبي، النازحان من جنوب لبنان في العام 1976، هرباً من الاجتياح الإسرائيلي، التقيا في وادي أبو جميل (الداون تاون حالياً) في 1980، وتزوّجا في 1981، وأنجبتني أمي في 27 آذار 1984.
كادت قسوة الحياة والفقر والقلّة أن يطعنوني حتّى قبل أن أولد. فكرة “إجهاضي” كانت متقدّمة، خوفاً من الجوع والقلّة. لكنّني صمدت بوجه محاولات، “فقيرة” هي الأخرى، بالقفز عن السرير أو وضع بلاطة اللحمة على الرحم. وفي الشهر الثالث والرابع والخامس، قبل الولادة، كان العناد قد تمكّن من تكويني حتّى قبل أن أولد.
ولدتُ تحت القصف في “بيروت الغربية”. بعد انتفاضة 6 شباط المجيدة. وقبل حرب المخيمات، الأكثر مجداً، بأشهر قليلة في 1985، وبعد الاجتياح الإسرائيلي بسنوات قليلة. وعلى مشارف حرب الأخوة في إقليم التفاح، وفي عزّ حروب عربية – عربية…
ولدتُ في بيروت تعجّ بالحروب، ومنطقة عربية يحكمها العسكر، فقيراً، لعائلة فقيرة. كانت أمي تحملنا كما تحمل القطط أبناءها، وتهرب بنا من قرنة إلى أخرى حين تقترب المعارك من بيوتنا الكثيرة والمتغيّرة والمتعدّدة.
عشت سنواتي الأولى بين المدرسة والملجأ. كان النزول إلى الملجأ في بيتنا بالرملة البيضاء واجباً دورياً. حتّى أنّني أحببت الملجأ لشدّة حميميته وكثرة المجتمعين فيه وأحاديثهم المسليّة. ومن حينها كلّما زفّ لنا أحدهم خبر حرب محتملة لا أشعر بالخوف بقدر ما أشعر بالحنين. فأنا ابن الحروب وربيبها.
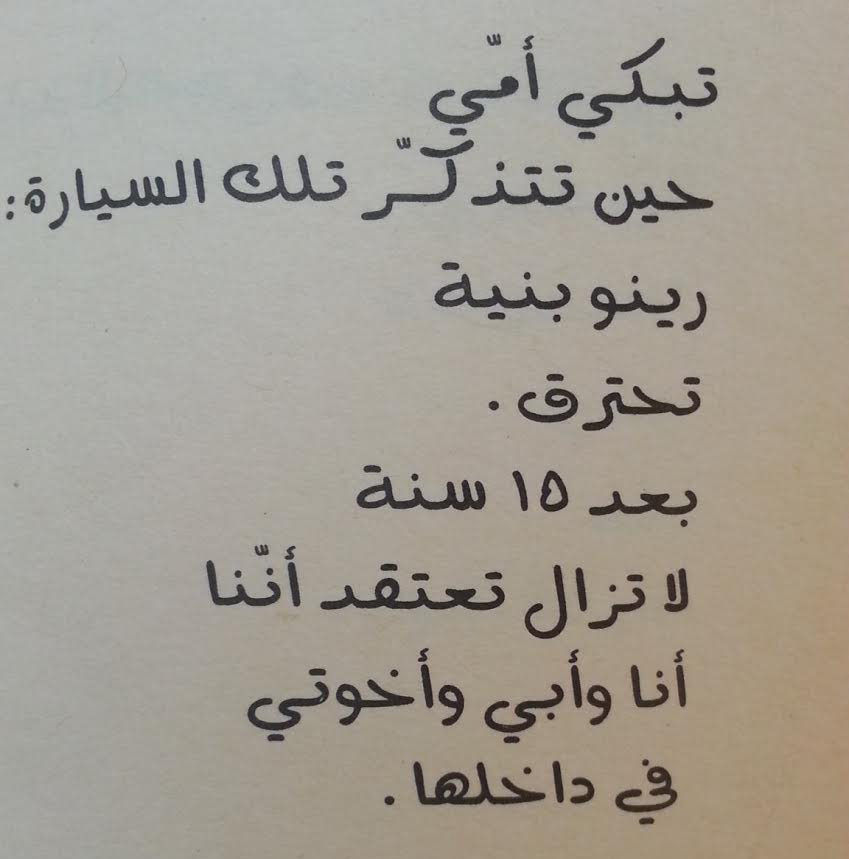
في “حرب عون” كنت في عامي الخامس. مجزرة الأونيسكو في 14 آذار 1989، نقلها التلفزيون على أنّها سيارة بنية تحترق وفي داخلها أطفال. مثل سيّارة والدي. يومها أغمي على أمّي وفقدت الوعي. في محاولتي الشعرية الأولى المنشورة بكتاب في 2005، كتبتُ: “تبكي أمي حين تتذكر تلك السيارة / رينو بنية / تحترق / بعد 15 سنة / لا تزال تعتقد أنّنا / أنا وأبي وأخوتي / في داخلها”.
في منزل كانت تملؤه الكتب، بين الأدب والعروبة والسياسة، تحسّست احتمالاتي. حروب وموت وقذائف من جهة، وكتب وأدب يحاول تفسير العالم من جهة أخرى. بين حنّا مينة وألبرتو مورافيا وعبد الرحمن منيف وغيرهم، ولدتُ. أنا المولود في عام تأسيس “حزب الله” أيضاً. رفاق كثيرون وجدوا أنفسهم يحملون السلاح، بعضهم صار مسؤولا وبعضهم استشهد. لكنّني اخترتُ الكتابة، رغم تحذيرات أمّي بأنّها “لا تطعمي خبزاً”.
بالعناد الغريزيّ الذي ورثته من أمّي درستُ الصحافة في الجامعة اللبنانية، رغم تحذيراتها. وبما حاولت وراثته من قدرة والدي العالية على النقد ورفض البديهيات، بدأت أكتب، باكراً جداً، في العام 2001، بملحق “النهار” الثقافي، عن 17 عاماً فقط. وكذلك في بعض صفحات الشباب التي كانت “تقليعة” بالجرائد اللبنانية.
حاولت في مقالاتي وكتبي اللاحقة أن أهرب من الحرب. أن أهرب من “جيل الحرب” وأن أكتب عن الحياة داخل جدران المنزل، وأن أصمّ آذان ذاكرتي عن الصواريخ والقذائف التي كانت تؤرّقنا وتهدّدنا.
في نهاية 2011 تزوّجت من فتاة جميلة وقعتُ في غرامها، وربّما لا أزال. في 10 كانون الثاني 2013 أنجبت لي كريم. عمره اليوم عامان وثلاثة أشهر تقريباً. كما هربت بنا أمي، حاولنا إبعاده عن بيروت وضاحيتها الجنوبية حين بدأت التفجيرات تضرب بين صيفي 2013 و2014.
ليست سيرة ذاتية. بكلّ حال لم تقرأوا إلا 450 كلمة حتّى الآن. سأختصر:
لم تتركني الحرب في حالي. هربت منها إلى الشعر. لحقت بي. إلى محاولات نصوص روائية. لحقت بي. إلى الزواج، لحقت بي التفجيرات إلى باب المنزل. اليوم أخاف على كريم وأقدّر لو أنّ أمي نجحت في إجهاضي، لكنتُ وفّرت على نفسي وعلى العالم الكثير.

“أدعسُ” اليوم في عامي الـ32. الرقم مخيف. لم يعد عشرينياً منذ سنتين. والرقم 2 بعد الثلاثين ينبىء بأنّ السبحة ستكرّ بسرعة نحو العشرة الرابعة. أحدهم قال لي مستفزّاً: أنت في عقدك الرابع الآن. وحين سمعتُه شعرت برجفة غريبة. وطرحت على نفسي أسئلة كثيرة، ليس أقلّها: ماذا فعلتَ حتّى الآن؟ وليس أكثرها: هل نجوتَ من الحرب التي ولدتَ فيها الساعة السادسة من فجر 27 آذار 1984؟
أدعس في عامي الـ32 وكلّي يقين أنّ كريم، طفلي الذي سيدخل المدرسة بعد أشهر، لن يعيش في عالم أقلّ قسوة. أدخل عقدي الرابع وقد تخلّصت من أوزار أحلام كثيرة. أحلام المساواة وبناء مجتمع الحريّات، أحلام الوطن والتحرّر، أو حتّى أحلام العدالة والقانون، التي لا أعرف لماذا لا تزال جزءًا من مناهج الأطفال. تلك التي نمضي أعمارنا في محاولة التخفّف منها، والسعي لنفهم أنّ “الحياة” هي حول كيفية كسر القوانين وتجاوزها، للخير أو للشرّ، وليس حول كيفية تطبيقها.
في يومي الأوّل من عامي الـ32 أشعر بسعادة غريبة لأنّني لا زلت على قيد الحياة. فأنا من الناجين، حتّى الآن، من مذابح الشرق. كلّ أحلامي أن أحمي طفلي، وحدي، أو ضمن مشروع يحمينا كلّنا، لا أراه من حولي في أيّ مكان.
في عيد ميلادي، كما في كلّ لحظة مررتُ بها، وفي كلّ الحروب التي عشتها إلى اليوم، أتأكّد أكثر فأكثر أنّنا متروكون للصدفة. ونحيا يوماً بيوم. لذا سأنهض وأُجلِسُ ابني في حضني، وأحاول أن أحبّه، طالما أنّنا لم ننحذف بعد من لوائح الناجين.
بعد الثلاثين تضيق الأحلام، فنخلعها لمن هم أصغر منّا. تماماً مثل ثياب نتناقلها من جيل إلى جيل، فلا هي تتمزّق، ولا نحن نقبل بأن نستمرّ في لبسها كلّ هذا الوقت… بعد الثلاثين أفكّر بالعودة إلى مقاعد الدراسة، في دراسة شيء جديد، أفكّر في تغيير مهنتي ربّما، لكثرة ما صرتُ أرى أربابها مصّاصي دماء.
في عيد ميلادي لا يخطر لي أكثر من أنّ الحلول فردية ليس إلا، وأنّ الأحلام الصغيرة هي كلّ ما يمكن أن أتمسّك به وكلّ ما تبقّى لي، ولنا. كأن أقبّل رأس طفلي، وأن أفكّر في ما سأعلّمه وأورّثه من أفكار، وفي لوح الشوكولا الذي سأشتريه له. في الجامعة التي سأكمل إجازة “الماستر” فيها، وفي لون الكنبة التي سأشتريها وقصّة شعر جديدة ربّما.
ربّما كلّ المشكلة أنّني أفكّر في العالم من حولي أكثر ممّا يجب، كما يفعل معظمنا، نحن معشر الفيسبوكيين. لكنّ العالم لن يصير أقلّ قسوة. على الأقلّ ليس في المدى المنظور. فقط، أنا، يمكن أن أشيح بنظري قليلاً. ليوم واحد على الأقلّ؟

